بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
يقال إن شرف العلم يعرف بشرف المعلوم ، وليس ثمة معلوم أشرف من الله جلَّ جلاله ،
إذ هو المتصف بصفات الكمال ، المنزه عن صفات النقص ، وما عرف العارفون ، ولا ذكر الذاكرون ، أشرف ولا أجل من الخالق سبحانه وتعالى .
لذلك كان العلم به من أجل العلوم وأعظمها ، بل هو أعظمها على الإطلاق ، وقد زخرت آيات الكتاب العظيم ، ونصوص السنة المطهرة ، بـأنواع أسماء الله عز وجل وصفاته ، وذلك منة من الله على عباده ، إذ عرفهم بنفسه جل وعلا ، حتى تكون عبادتهم له على علم وبصيرة .
وقد كان منهج السلف في التعامل مع نصوص أسماء الله وصفاته يتسم بالعلم والحكمة معا ، فهم قد وقفوا من تلك الأسماء والصفات موقف المثبت لها على الوجه اللائق به سبحانه ، مع نفيهم أن تكون تلك الصفات مماثلة لصفات المخلوقين ، ومع استبعاد أي تدخل للعقل في تحديد كيفيتها ، أو تعطيل حقيقتها ، أو تحريفها عن الوجه الذي يدل عليه ظاهر اللفظ .
وهذا المنهج على سلامته العلمية يورث القلب راحة ، وطمأنينة ، وذلك لسهولة إدراك المعنى المراد من اللفظ .
ومن منهج السلف في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته ، الحرص على حفظها ، والعمل بمقتضياتها ، وقد ورد في فضل ذلك أجر عظيم ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال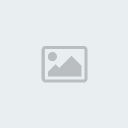 إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه ، وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا . .. ) .
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه ، وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا . .. ) .
ومن منهج السلف في أسماء الله وصفاته دعاؤه بها والتضرع إليه بمعانيها ، قال تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون }( الأعراف:180) .
ومن منهج السلف في أسماء الله وصفاته أيضاً : اتخاذها منهجاً في التعرف على الخالق سبحانه والتقرب إليه ، فهي مفاتيح المعرفة به سبحانه ، وبها يترقى العبد في درجات الأنس بالله جلا وعلا .
هذه بعض جوانب منهج السلف في أسماء الله وصفاته ، وهو منهج يجمع بين العلم والعمل معا .
لذا فالواجب على المسلم أن يفهم هذا المنهج وأن يطبقه ، ليحصل له العلم بالله ، على الوجه المطلوب .
قواعد في الأسماء والصفات
تميز منهج السلف - رحمهم الله – في باب الأسماء والصفات وفي غيره بالسهولة والانضباط، فهو سهل في إدراكه، منضبط في أركانه، ولا غرابة في ذلك، إذ هو منهج يقوم على الأخذ بنور الوحيين، وسلوك طريق النبيين والصديقين، ومن هنا أخذ العلماء في دراسة ذلك المنهج وتحليله، واستخرجوا منه القواعد التي سار عليها السلف في باب أسماء الله وصفاته، وهي قواعد تتميز بسهولة فهمها وتطبيقها .
من تلك القواعد الإيمان بما جاء عن الله وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضة شيء منهما أو رده بهوى أو قياس أو رأي، وإنما التسليم الكامل لهما، فإذا ورد في الكتاب مثلاً قوله تعالى:{ وهو العليم القدير }(الروم:54)، وجب الإيمان بذلك وإثبات صفتي العلم والقدرة له سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهكذا الحال مع كل الصفات التي ثبتت بالأدلة المعتبرة .
ومن القواعد أيضا ما قرره العلماء من وجوب إجراء نصوص الصفات على ما دل عليه ظاهر اللفظ على الوجه اللائق به سبحانه، فإذا جاء النص بإثبات السمع لله في نحو قوله تعالى: { وهو السميع العليم }(البقرة: 137) فإن موقف السلف من ذلك هو إثبات صفة السمع له سبحانه على الوجه اللائق به، وعليه نقول: إن لله عز وجل سمعا يليق بجلاله، قد أحاط بكل مسموع، لا يخفى عليه صوت، عظم هذا الصوت أم خفت، فهو يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
وهكذا صفة البصر، فلله عز وجل بصر يليق بجلاله يدرك به جميع المبصرات، لا يحجبه شيء عن شيء، مهما كبر أو صغر، وهكذا القول في سائر الصفات .
ومن القواعد أيضاً: أن المعنى المتبادر إلى الذهن عند ذكر صفات الرب جل جلاله، ليس هو المعنى المماثل لصفات المخلوقين، فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الاستواء مثلاً، في نحو قوله تعالى:{ الرحمن على العرش استوى }(طـه:5 )
فلا يفهم من هذه الصفة المعنى المختص بالمخلوق، بل كل صفة تتحدد بحسب ما تضاف إليه، وعليه فافتراق الخالق عن المخلوق في استوائه واضح بين، فللمخلوق استواء يليق به، ولله عز وجل استواء يليق به أيضا، فإذا كان استواء العباد يدل على حاجتهم وافتقارهم لما استووا عليه فلا يدل ذلك في حق الله قطعا، لذلك عندما سئل الإمام مالك عن آية الاستواء وقيل له: كيف استوى ؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
ومعنى كلام الإمام مالك : أن الاستواء لغةً معلوم، وهو في آية الاستواء العلو والارتفاع، أما كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة فهذا ما نجهله، والإيمان بهذا القدر – أعني المدلول اللغوي - واجب، وهو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة، نهى عنها الشرع المطهر. فلم ينف الإمام مالك صفة الاستواء عن الله عز وجل، بل أثبتها، ونفى علمه بالكيفية، عملا بهذه القاعدة.
والذين توهموا أن الصفات الواردة في حق الله سبحانه تماثل صفات المخلوقين وقعوافي محاذير منها:
الأول: أنهم أخطؤوا فهم مراد الله سبحانه فظنوا أن مدلول النصوص هو التمثيل.
الثاني: أنهم عندما جعلوا مفهوم الصفات مماثلة لصفات المخلوقين عطلوا الله عن المعاني الإلهية اللائقة بجلاله والتي أودعها في صفاته.
الثالث: أنهم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات، من صفات الأموات والجمادات أوصفات المعدومات، فعطلوا الرب عن صفات الكمال التي يستحقها، ومثلوه بالمنقوصات والمعدومات فكان ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته.
ومن القواعد أيضا أن العقل قد دل على ما دل عليه السمع من اتصاف الله بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص، فلا تعارض بين سمع صحيح وعقل صريح، بل يؤيد أحدهما الآخر، وما ظُنَّ أنه معارض للعقل لو وزن بالميزان الصحيح لعلم أنه من المجهولات لا من المعقولات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل كذلك الحب والرضا والغضب، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يُعلم بالعقل .. ومن الطرق العقلية التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في إثبات الصفات، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين: للزم اتصافه بالأخرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم .. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى".
ومن القواعد أيضاً: أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أن من لم يثبت لله سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، ثم هو في المقابل يثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فيقال له: كما أثبتَّ لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت لله سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وقل مثل ذلك في سائر الصفات الثابتة، وهذه حجة واضحة وملزمة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات .
هذا هو منهج السلف في الجانب النظري منه، أما منهجهم العملي في التعامل مع أسماء الله وصفاته فتمثل في الحرص على حفظها، والعمل بمقتضاها، لترغيبه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما روى البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال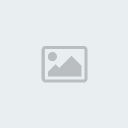 إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد في دعاء الهم والحزن مرفوعا: ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. ) .
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد في دعاء الهم والحزن مرفوعا: ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. ) .
ومن العمل بمقتضى الأسماء والصفات دعاء الله بها، ولهذا قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } ( الأعراف:180).
ومن العمل بمقتضى الأسماء والصفات معرفة مدلولاتها ومعانيها والتزام ذلك، فإذا علم العبد أن الله سميع راعى الله فيما يقول فلم يقل إلا خيرا، وإذا علم أن الله بصير راقب الله فيما يعمل فلا يراه الله في معصيته، وإذا علم أن الله قدير لم يظلم ولم يعتد، وهكذا تعامله مع سائر الصفات.
هذا هو منهج السلف في الإيمان بأسماء الله وصفاته، وتلك هي قواعدهم، وهي قواعد سهلة في أخذها، سهلة في تطبيقها، عرف السلف بها صفات ربهم، وتقربوا إليه بذكرها، ودعوه وأثنوا عليه بها، وعملوا بمقتضاها، ولم يقتصر إيمانهم بها على الجانب النظري فحسب، بل رسخت معاني تلك الصفات الربانية في نفوسهم، واستشعروها في حياتهم العملية، فأورثهم الله سعادة ورضا في الدنيا، والفوز والفلاح في الآخرة .
أما الاستدلال بحديث ( كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء ) رواه النسائي . على نفي العلو، فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه، وذلك أن الحديث يتكلم عن بدء الخلق، وأن الله كان ولا شيء معه من مخلوقاته، وأن أول خلقه كان العرش، بدليل ما رواه الحاكم في مستدركه عن بريدة الأسلمي قال: " دخل قوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يسألونه، يقولون: أعطنا حتى ساءه ذلك، ودخل عليه آخرون، فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونتفقه في الدين، ونسأله عن بدء هذا الأمر، فقال: ( كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء ).
أما ما روي من قولهم: " كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه". فهو أثر موضوع – كما قال العلماء - على أنه يمكن حمله على معنى صحيح، وهو أن يكون المكان المنفي هو المكان المخلوق – كما هو ظاهر النص - وأهل السنة يقولون بذلك، فهم لا يقولون أن الله متمكن في مكان مخلوق بل يقولون: إن الله مستو على العرش بمعنى أنه عال عليه لا أنه مماس له محتاج إليه .
فظهر بهذا أن لا تعارض بين العقل والنقل في إثبات علو الله – سبحانه - على خلقه واستواءه على عرشه بل هو مما اتفقا عليه، وتظافرت الأدلة على إثباته، وأن من أنكره إنما استند إلى بعض النقول التي بان وجه الحق فيها، أو إلى بعض الأدلة العقلية التي اتضح عدم صحتها . فعلى المسلم أن يثبت لله الصفات كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وأن يعلم أن الله لم يخبر عن نفسه بما هو محال أو ممتنع، وإنما أخبر بما هو جائز أو واجب في حقه، ليعرف العباد خالقهم فيتقربوا إليه، ويعبدوه عن علم ودراية .
يقال إن شرف العلم يعرف بشرف المعلوم ، وليس ثمة معلوم أشرف من الله جلَّ جلاله ،
إذ هو المتصف بصفات الكمال ، المنزه عن صفات النقص ، وما عرف العارفون ، ولا ذكر الذاكرون ، أشرف ولا أجل من الخالق سبحانه وتعالى .
لذلك كان العلم به من أجل العلوم وأعظمها ، بل هو أعظمها على الإطلاق ، وقد زخرت آيات الكتاب العظيم ، ونصوص السنة المطهرة ، بـأنواع أسماء الله عز وجل وصفاته ، وذلك منة من الله على عباده ، إذ عرفهم بنفسه جل وعلا ، حتى تكون عبادتهم له على علم وبصيرة .
وقد كان منهج السلف في التعامل مع نصوص أسماء الله وصفاته يتسم بالعلم والحكمة معا ، فهم قد وقفوا من تلك الأسماء والصفات موقف المثبت لها على الوجه اللائق به سبحانه ، مع نفيهم أن تكون تلك الصفات مماثلة لصفات المخلوقين ، ومع استبعاد أي تدخل للعقل في تحديد كيفيتها ، أو تعطيل حقيقتها ، أو تحريفها عن الوجه الذي يدل عليه ظاهر اللفظ .
وهذا المنهج على سلامته العلمية يورث القلب راحة ، وطمأنينة ، وذلك لسهولة إدراك المعنى المراد من اللفظ .
ومن منهج السلف في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته ، الحرص على حفظها ، والعمل بمقتضياتها ، وقد ورد في فضل ذلك أجر عظيم ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
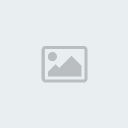 إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه ، وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا . .. ) .
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه ، وحزنه ، وأبدله مكانه فرجا . .. ) .ومن منهج السلف في أسماء الله وصفاته دعاؤه بها والتضرع إليه بمعانيها ، قال تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون }( الأعراف:180) .
ومن منهج السلف في أسماء الله وصفاته أيضاً : اتخاذها منهجاً في التعرف على الخالق سبحانه والتقرب إليه ، فهي مفاتيح المعرفة به سبحانه ، وبها يترقى العبد في درجات الأنس بالله جلا وعلا .
هذه بعض جوانب منهج السلف في أسماء الله وصفاته ، وهو منهج يجمع بين العلم والعمل معا .
لذا فالواجب على المسلم أن يفهم هذا المنهج وأن يطبقه ، ليحصل له العلم بالله ، على الوجه المطلوب .
قواعد في الأسماء والصفات
تميز منهج السلف - رحمهم الله – في باب الأسماء والصفات وفي غيره بالسهولة والانضباط، فهو سهل في إدراكه، منضبط في أركانه، ولا غرابة في ذلك، إذ هو منهج يقوم على الأخذ بنور الوحيين، وسلوك طريق النبيين والصديقين، ومن هنا أخذ العلماء في دراسة ذلك المنهج وتحليله، واستخرجوا منه القواعد التي سار عليها السلف في باب أسماء الله وصفاته، وهي قواعد تتميز بسهولة فهمها وتطبيقها .
من تلك القواعد الإيمان بما جاء عن الله وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضة شيء منهما أو رده بهوى أو قياس أو رأي، وإنما التسليم الكامل لهما، فإذا ورد في الكتاب مثلاً قوله تعالى:{ وهو العليم القدير }(الروم:54)، وجب الإيمان بذلك وإثبات صفتي العلم والقدرة له سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهكذا الحال مع كل الصفات التي ثبتت بالأدلة المعتبرة .
ومن القواعد أيضا ما قرره العلماء من وجوب إجراء نصوص الصفات على ما دل عليه ظاهر اللفظ على الوجه اللائق به سبحانه، فإذا جاء النص بإثبات السمع لله في نحو قوله تعالى: { وهو السميع العليم }(البقرة: 137) فإن موقف السلف من ذلك هو إثبات صفة السمع له سبحانه على الوجه اللائق به، وعليه نقول: إن لله عز وجل سمعا يليق بجلاله، قد أحاط بكل مسموع، لا يخفى عليه صوت، عظم هذا الصوت أم خفت، فهو يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
وهكذا صفة البصر، فلله عز وجل بصر يليق بجلاله يدرك به جميع المبصرات، لا يحجبه شيء عن شيء، مهما كبر أو صغر، وهكذا القول في سائر الصفات .
ومن القواعد أيضاً: أن المعنى المتبادر إلى الذهن عند ذكر صفات الرب جل جلاله، ليس هو المعنى المماثل لصفات المخلوقين، فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الاستواء مثلاً، في نحو قوله تعالى:{ الرحمن على العرش استوى }(طـه:5 )
فلا يفهم من هذه الصفة المعنى المختص بالمخلوق، بل كل صفة تتحدد بحسب ما تضاف إليه، وعليه فافتراق الخالق عن المخلوق في استوائه واضح بين، فللمخلوق استواء يليق به، ولله عز وجل استواء يليق به أيضا، فإذا كان استواء العباد يدل على حاجتهم وافتقارهم لما استووا عليه فلا يدل ذلك في حق الله قطعا، لذلك عندما سئل الإمام مالك عن آية الاستواء وقيل له: كيف استوى ؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
ومعنى كلام الإمام مالك : أن الاستواء لغةً معلوم، وهو في آية الاستواء العلو والارتفاع، أما كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة فهذا ما نجهله، والإيمان بهذا القدر – أعني المدلول اللغوي - واجب، وهو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، والسؤال عن الكيفية بدعة، نهى عنها الشرع المطهر. فلم ينف الإمام مالك صفة الاستواء عن الله عز وجل، بل أثبتها، ونفى علمه بالكيفية، عملا بهذه القاعدة.
والذين توهموا أن الصفات الواردة في حق الله سبحانه تماثل صفات المخلوقين وقعوافي محاذير منها:
الأول: أنهم أخطؤوا فهم مراد الله سبحانه فظنوا أن مدلول النصوص هو التمثيل.
الثاني: أنهم عندما جعلوا مفهوم الصفات مماثلة لصفات المخلوقين عطلوا الله عن المعاني الإلهية اللائقة بجلاله والتي أودعها في صفاته.
الثالث: أنهم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات، من صفات الأموات والجمادات أوصفات المعدومات، فعطلوا الرب عن صفات الكمال التي يستحقها، ومثلوه بالمنقوصات والمعدومات فكان ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته.
ومن القواعد أيضا أن العقل قد دل على ما دل عليه السمع من اتصاف الله بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص، فلا تعارض بين سمع صحيح وعقل صريح، بل يؤيد أحدهما الآخر، وما ظُنَّ أنه معارض للعقل لو وزن بالميزان الصحيح لعلم أنه من المجهولات لا من المعقولات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل كذلك الحب والرضا والغضب، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يُعلم بالعقل .. ومن الطرق العقلية التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في إثبات الصفات، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين: للزم اتصافه بالأخرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم .. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى".
ومن القواعد أيضاً: أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أن من لم يثبت لله سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، ثم هو في المقابل يثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فيقال له: كما أثبتَّ لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت لله سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وقل مثل ذلك في سائر الصفات الثابتة، وهذه حجة واضحة وملزمة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات .
هذا هو منهج السلف في الجانب النظري منه، أما منهجهم العملي في التعامل مع أسماء الله وصفاته فتمثل في الحرص على حفظها، والعمل بمقتضاها، لترغيبه صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما روى البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
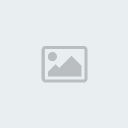 إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد في دعاء الهم والحزن مرفوعا: ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. ) .
إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) . ولا يعني هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في تسعة وتسعين اسماً، بل لله عز وجل من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو . كما ثبت في مسند الإمام أحمد في دعاء الهم والحزن مرفوعا: ( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك .. ) .ومن العمل بمقتضى الأسماء والصفات دعاء الله بها، ولهذا قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } ( الأعراف:180).
ومن العمل بمقتضى الأسماء والصفات معرفة مدلولاتها ومعانيها والتزام ذلك، فإذا علم العبد أن الله سميع راعى الله فيما يقول فلم يقل إلا خيرا، وإذا علم أن الله بصير راقب الله فيما يعمل فلا يراه الله في معصيته، وإذا علم أن الله قدير لم يظلم ولم يعتد، وهكذا تعامله مع سائر الصفات.
هذا هو منهج السلف في الإيمان بأسماء الله وصفاته، وتلك هي قواعدهم، وهي قواعد سهلة في أخذها، سهلة في تطبيقها، عرف السلف بها صفات ربهم، وتقربوا إليه بذكرها، ودعوه وأثنوا عليه بها، وعملوا بمقتضاها، ولم يقتصر إيمانهم بها على الجانب النظري فحسب، بل رسخت معاني تلك الصفات الربانية في نفوسهم، واستشعروها في حياتهم العملية، فأورثهم الله سعادة ورضا في الدنيا، والفوز والفلاح في الآخرة .
أما الاستدلال بحديث ( كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء ) رواه النسائي . على نفي العلو، فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه، وذلك أن الحديث يتكلم عن بدء الخلق، وأن الله كان ولا شيء معه من مخلوقاته، وأن أول خلقه كان العرش، بدليل ما رواه الحاكم في مستدركه عن بريدة الأسلمي قال: " دخل قوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يسألونه، يقولون: أعطنا حتى ساءه ذلك، ودخل عليه آخرون، فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونتفقه في الدين، ونسأله عن بدء هذا الأمر، فقال: ( كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء ).
أما ما روي من قولهم: " كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه". فهو أثر موضوع – كما قال العلماء - على أنه يمكن حمله على معنى صحيح، وهو أن يكون المكان المنفي هو المكان المخلوق – كما هو ظاهر النص - وأهل السنة يقولون بذلك، فهم لا يقولون أن الله متمكن في مكان مخلوق بل يقولون: إن الله مستو على العرش بمعنى أنه عال عليه لا أنه مماس له محتاج إليه .
فظهر بهذا أن لا تعارض بين العقل والنقل في إثبات علو الله – سبحانه - على خلقه واستواءه على عرشه بل هو مما اتفقا عليه، وتظافرت الأدلة على إثباته، وأن من أنكره إنما استند إلى بعض النقول التي بان وجه الحق فيها، أو إلى بعض الأدلة العقلية التي اتضح عدم صحتها . فعلى المسلم أن يثبت لله الصفات كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وأن يعلم أن الله لم يخبر عن نفسه بما هو محال أو ممتنع، وإنما أخبر بما هو جائز أو واجب في حقه، ليعرف العباد خالقهم فيتقربوا إليه، ويعبدوه عن علم ودراية .

